قراءة في دراسة "التجربة العسكرية الفلسطينية.. ملاحظات في النظرية والأداء"
13 يوليو 2025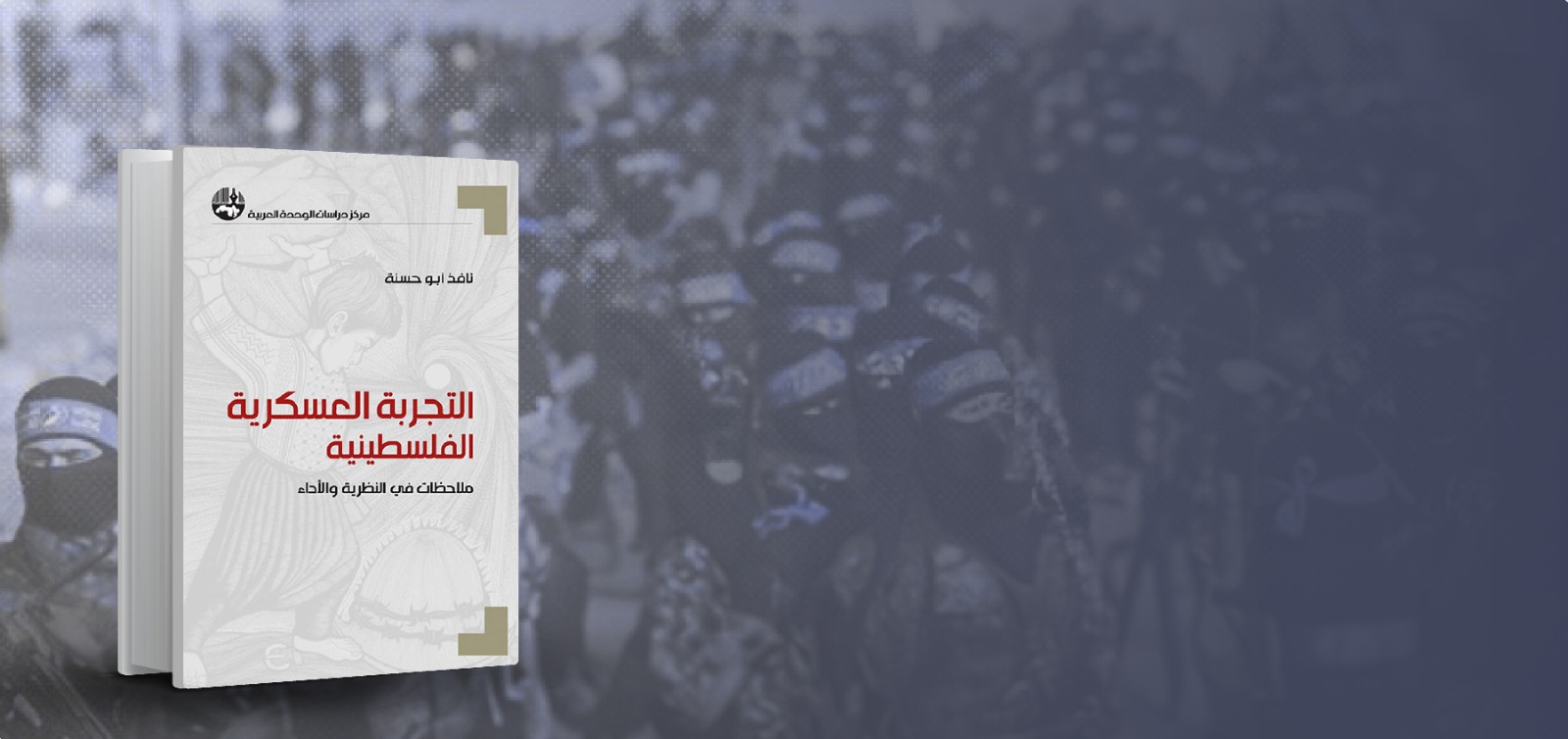
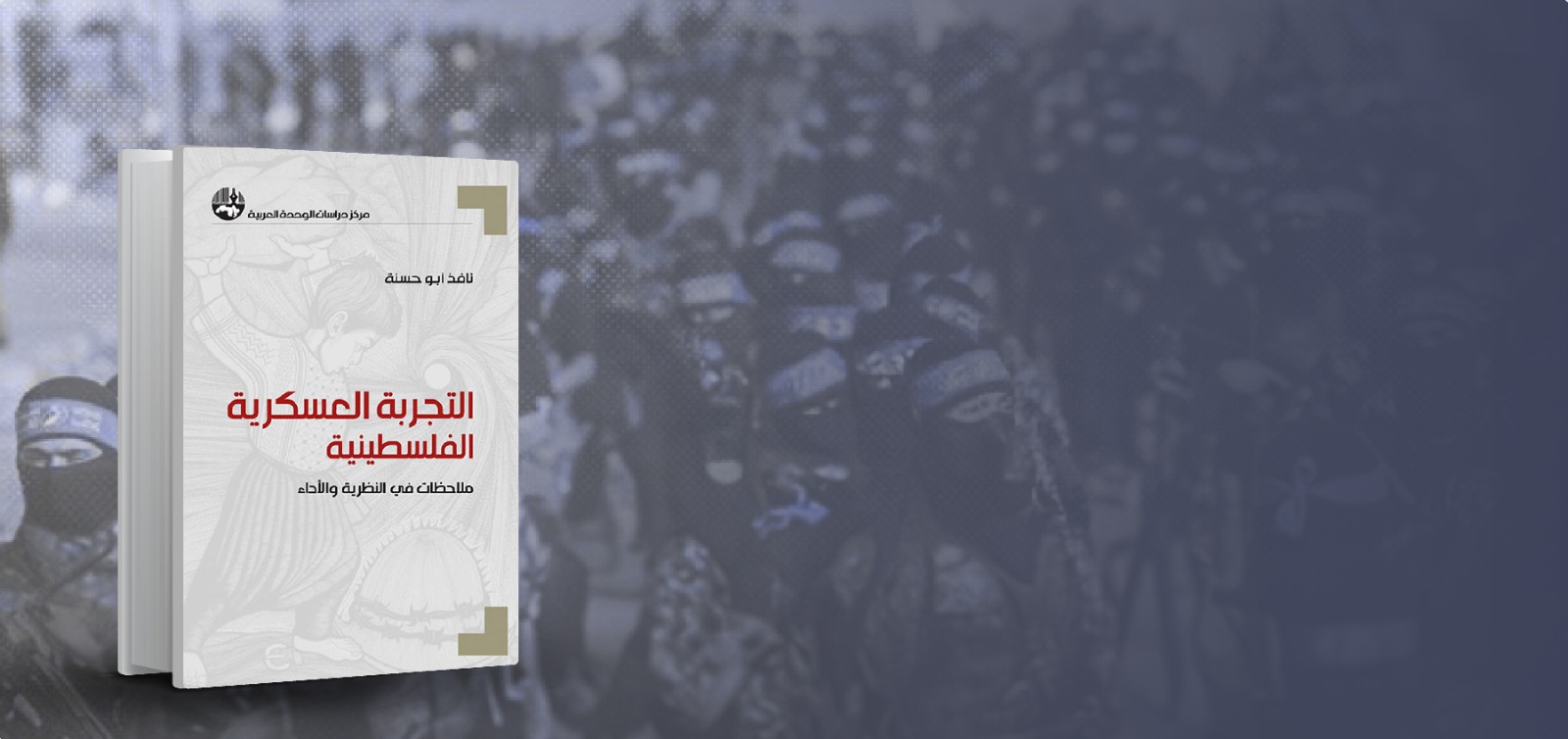
تعد دراسة "التجربة العسكرية الفلسطينية.. ملاحظات في النظرية والأداء" للكاتب نافذ أبو حسنة، والمنشورة من خلال مركز دراسات الوحدة العربية عام 2022، توثيقا مهما للتجربة العسكرية النضالية الفلسطينية منذ الثورات الأولى وحتى الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
قدّم الكاتب التجربة الفلسطينية بشكل واضح ومبسط، ووضع نقاط القوة ونقاط الضعف والتقصير في كل مرحلة من مراحل العمل الفلسطيني العسكري، وخلال القراءة لاحظت وجود تشابه كبير، خاصة في ردات الفعل "الإسرائيلية" على الفعل المقاوم في السبعينيات، ورده على المقاومة بعد طوفان الأقصى، إضافة الى وجود نقاط تشابه واضحة بين المقاومة الفلسطينية خاصة في السبعينيات وبعد عام 2020، ولعل المطلوب إعادة لقراءة واعية للتاريخ والتجربة الفلسطينية، والخروج بنتائج تنعكس إيجابا على الفعل الفلسطيني المقاوم.
المطلوب إعادة لقراءة واعية للتاريخ والتجربة الفلسطينية، والخروج بنتائج تنعكس إيجابا على الفعل الفلسطيني المقاوم.
بدأ الكتاب بفصل تمهيدي تناول فلسطين كموقع وتاريخ، والإرث الجهادي الفلسطيني الممتد منذ المواجهة الأولى في عام 1877 في قرية ملبس، وما لحقه من ثورة القسام والثورات الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني. يقدم الكاتب التجربة من خلال مجموعة من العمليات الفلسطينية وتحليل هذه العمليات وردات الفعل عليها ومناقشتها.
ينتقل الكاتب إلى حرب ال1948 ويقدم مجموعة حقائق مهمة عن هذه الحرب، إضافة إلى مقارنات بين الجيوش العربية وجيش الاحتلال، وكذلك حرب عام 1967 وحرب عام 1973 وحرب الكرامة.
كما أفرد الكاتب بابا كاملا للحديث عن العمليات الاستشهادية؛ ما لها وما عليها ودورها في العمل الفلسطيني العسكري، كما قدّم الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية بشكل جميل جدا، جمع كل ما يتعلق بها من معلومات وتحاليل لم أكن قد قرأتها سابقا في أي كتاب تناول هذه المرحلة المهمة من التاريخ الفلسطيني.
وشد انتباهي فكرة تهجير الفلسطينيين والقضاء على المخيمات، والخطة الموضوعة منذ السبعينيات، وكيف سعى الاحتلال إلى تطبيقها، وأقارن ذلك بما يحدث الآن بعد طوفان الأقصى لأجد تشابها كبيرا بين المرحلتين.
"من المؤكد أنه لا يمكن تغيير الظروف الجغرافية، ولكن من المؤكد أيضًا أنه من الممكن إيجاد الوسائط المناسبة للتعامل معها، والسعي نحو الابتكار بتوظيفها إلى أبعد حد ممكن، حتى عندما يتعلق الأمر بزرع الألغام، فتربة القطاع تعني أنك لا تستطيع إبقاء اللغم وقتًا طويلا في مكانه."
"مارست قوات الاحتلال نوعًا من الإبادة المنظمة ضد الثوار الفلسطينيين، وسعت إلى استعداء الجماهير عليهم من طريق التنكر بزي الفدائيين وإساءة معاملة الناس، وتوجيه تهمة التعامل والخيانة لهم. ودخول البيوت في الليل والنهار، بحجة طلب المساعدة والاختباء، ثم التنكيل بأصحاب البيوت في ما بعد، وإلقاء قنابل على تجمعات الأهالي في الشوارع، والادعاء بأن الفدائيين هم وراء ذلك، وتسليح المتعاونين، وتحريض (القبائل والعشائر) بعضها على بعض."
"خلفت حرب تشرين نتائج متعاكسة على العمل العسكري الفلسطيني، فمن ناحية رفعت الروح المعنوية للجماهير الفلسطينية والعربية، وشهدت التنظيمات الفلسطينية المسلحة اندفاعه جديدة من الشباب العربي للالتحاق بها على غرار ما حدث عقب معركة الكرامة. ومن ناحية ثانية بدا التوظيف السياسي مهيمنا على الأنشطة العسكرية وخصوصا عقب التحركات السياسية التي تلت الحرب، واعتماد برنامج سياسي فلسطيني عرف باسم (البرنامج المرحلي) خلّف انقساما حادا بين التنظيمات الفلسطينية."
"من المفهوم أن تعزيز البنية العسكرية أمر جيد جدا، وكذلك اكتساب الخبرات والتزود بالمعدات والتكنولوجيا، لكن السؤال يظل قائما حول مدى مطابقة ذلك لحاجات المعركة الفلسطينية. لقد تحوّل البناء المؤسسي في كثير من الأحيان إلى عبء تتوجب حمايته، ليس بالقوة العسكرية فقط، بل بتعقيدات وتنازلات للمحافظة عليه، وبالتالي، احتل الحفاظ على المؤسسة والبنية مكان التحرك النشط للاشتباك الدائم مع العدو وإنهاكه."
"من المفهوم أن وجود الاحتلال يستدعي المقاومة، وينتج المعادلة القائلة بأنه طالما بقي هناك احتلال فستكون مقاومة لهذا الاحتلال. وعلى مدى نحو قرن من الزمن كانت هذه المعادلة قائمة في فلسطين، وينطلق كل حديث عن عوامل تفجر الانتفاضة بالاستناد إلى هذه المعادلة الأساسية. هنا يذهب البعض إلى القول بأن الانتفاضة إنما جاءت تعبيرا عن يأس الفلسطينيين من تقدم عملية التسوية، وغالبا ما أثار مثل هذا القول نقاشا طويلا، إذ كان المقصود منه ومنذ البداية ربط الانتفاضة بعملية استثمار سياسي بائس، والحث على تحريك التسوية لوقف الفعل الجهادي في فلسطين، لكن الانتفاضة لم تطالب بالمفاوضات بل بإنهاء الاحتلال، وبينت الوقائع العنيدة الافتراق الكبير بين الأهداف التي أراد الشعب الفلسطيني تحقيقها وبين مآل الاستثمار السياسي للانتفاضة والذي لم ينهِ الاحتلال."
"تعَدّ الانتفاضة تجربة نضالية مميزة عمّا سبقها من تجارب فلسطينية وعربية، وعالمية في خوض الكفاح ضد المحتل. فإذا كان استنباط الشكل الكفاحي الملائم، هو المؤشر على مدى نجاح المكافحين في تحقيق أهدافهم، فإن هذا الأمر ينطبق على الانتفاضة الكبرى، إذ كان على الشعب الفلسطيني أن يختار تكتيكه في مواجهة أعدائه، مستفيدًا من تجربته الخاصة ومن تجارب الشعوب، ومتعمقًا في دراسة الظروف الذاتية والموضوعية، نقاط القوة ونقاط الضعف، وطبيعة وحجم العدو الذي يواجهه والمتمتع بتفوق بشري، وآلة عسكرية ضخمة، وعصابات المستوطنين، وأجهزة أمنية متعددة ومتشابكة تمتد عبر شبكة العملاء إلى داخل صفوف الشعب الفلسطيني. كل هذا في غياب أدوات الكفاح المسلح التقليدية، وشبه انتقاء لإمكاناته، حيث لا جبال عالية وعرة، ولا غابات كثيفة وحدود مغلقة بشبكات الألغام والإنذار المبكر وشتى أنواع الحواجز الأخرى."
"إن العمل العسكري الفلسطيني سيبقى موجودا ما دمنا نحن على أرض فلسطين وما دام هذا الاحتلال قائما، ولكن علينا أن نعتمد الخطة والتنظيم السري المسلح. لقد مثلت العلنية مقتلا لنا، وظاهرة المطاردين يجب إنهاؤها، فالمطارد شخص عاجز مشلول لا يستطيع أن يبدع في أساليب وخطط القتال، إذ من الطبيعي أن ينشغل بأمنه وحماية نفسه من الاستهداف، فكيف سيعمل حينذاك؟"
"ينبغي أيضا حل مشكلة التكامل بين كل وسائط العمل الكفاحي، بأن تنصرف العلنية نحو المقاومة السلبية، تظاهرات، واعتصامات، وحتى رشق حجارة ومولوتوف، أما العمل العسكري فينبغي أن يكون من شأن التنظيم السري ووفق خطة محكمة طالما افتقدناها، وأيضا من دون أن يعيب أحد على الآخر ما يقوم به من عمل، بمعنى أن التظاهرة مهمة بقدر ما هي العملية الاستشهادية مهمة، هذه صحيحة وهذه صحيحة، وهذه مطلوبة وتلك مطلوبة، ولكن كيف؟"
"إن المقاومة بالحجر وصولا إلى المقاومة بالصاروخ والعمل الاستشهادي والاشتباك والاقتحام والكمين، هي أنماط فعل متكاملة، ولكي ينبغي تحديد آلياتها وفقا لحسابات سياسية وميدانية، هذا يتطلب وجود قيادة موحدة، وعمل استخباري، وتدريب، وتسلح مناسب، وحسن اختيار للأهداف، وهذه مسألة دقيقة جدا. وهي مرتبطة بحسابات سياسية وميدانية، ومن السهل على القيادات ذات الخبرة المتوافرة أن تقوم بتعيين الأهداف وفقا لتشخيص نقاط الضعف لدى العدو جيشا ومستوطنين، والتركيز على هذه النقاط. ولترتيب معرفة نقاط قوتنا، والإجابة عن السؤال: ما هي أشكال العمل العسكري التي تتناسب مع قدراتنا، ومع واقع الاحتلال، ومع طبيعة الأرض والسكان، وتتوافق مع الحسابات السياسية والميدانية. وإذا توافر كل ذلك، فسوف تدخل التجربة طورا جديدا."
"انبنى الجانب الأكبر من الجهد القتالي الفلسطيني على كونه رد فعل. ولم يمتلك عنصر المبادرة إلا في أوقات قليلة، وحين امتلكها فإنه لم يحسن تطويرها. إن البطولات التي أبداها المقاتلون والمجاهدون الفلسطينيون منذ بدء الصراع، توجب الانحناء لها، لكن في المقابل (وعدا بعض الحالات) فإن الروح الاقتحامية الهجومية التي تزلزل العدو وتزرع الرعب في أوصاله ظلت غائبة، وحين وقوعها فإنها لم تكن موضوعة ضمن خطة منهجية تصاعدية أي تضمن الاستمرار، وإنما بدت مثل انعطافات في خط بياني متذبذب.التصرف الغالب بمنطق رد الفعل فرض دوما تحركات بلا خطة، وأحيانا بلا أهداف واضحة حتى."
"سيطر النفس الاستعراضي ومنطق (الطوشة) على الأداء القتالي منذ بدايته وحتى الآن، ولعله من المناسب أن نتساءل لماذا تخوض المقاومة في لبنان صراعا ضاريا وتهزم العدو من دون أن ترى أيا من جنرالات المقاومة يظهر على شاشة التلفزيون لا ملثما ولا حاسر الرأس، بينما يتسابق (الشباب) إلى عقد المؤتمرات الصحافية بمناسبة أو دون مناسبة، وينظمون استعراضات لملثمين ليس من داع لظهورهم أصلا؟"
"إن افتقاد القيادة الفلسطينية، للخط العسكري الواضح والصحيح بعد انقلابها على استراتيجية حرب الشعب ذات النفس الهجومي، في أواسط السبعينيات، جعل المسيرة العسكرية تتخبط في تكتيكات قتالية متنوعة، ذات نفَس دفاعي على الأغلب، راوحت بين حرب العصابات التقليدية، وحرب العصابات المتطورة، بين حرب المدن والشوارع الثورية، إلى حرب المواقع النظامية، من دون أن تكون قادرة على ضبط الأداء القتالي، أو السيطرة على تطور كل تكتيك، وتركت للقيادات الميدانية والإقليمية المترفة والفاسدة على الأغلب، هامشا واسعا للمناورة وللارتجال في الأساليب القتالية."